مونتريال- دارين حوماني
مع بداية العام الدراسي، تتجدد الأسئلة والمخاوف حول مدى جهوزية المؤسسات التربوية في مونتريال الكبرى لاستقبال آلاف التلاميذ. فقرار الحكومة بخفض تمويل التعليم، وإن جرى التراجع عنه جزئيًا عبر تخصيص اعتمادات إضافية في تموز/ يوليو الماضي، ترك أثره العميق على المدارس، حيث شعر المعلمون والأهالي معًا بانعكاس تقليص الميزانية على الخدمات التربوية والدعم النفسي والأنشطة الموازية التي لم تعد ممكنة داخل الصفوف.
وتتعقد المشهدية أكثر مع استمرار تطبيق القانون رقم 21، الذي يمنع الموظفين الحكوميين من ارتداء الرموز الدينية، بما في ذلك المعلمات، ما يفاقم أزمة النقص في الكوادر التربوية، ويؤدي إلى اكتظاظ الصفوف ما يؤثر على إنتاجية الطلاب، وإلى تراجع قدرة المعلمات على متابعة احتياجات جميع التلاميذ.
إلى جانب هذه التحديات البنيوية، يواجه الأهالي هواجس يومية تبدأ بكلفة الكتب واللوازم، ولا تنتهي عند القلق من مناهج الهوية الجندرية للاطفال (LGBTQ) أو من انتشار ظاهرة المخدرات بين المراهقين وما يمكن أن يتعرض له أبناؤهم داخل البيئة المدرسية.
في هذا التحقيق، نستعرض شهادات من أمهات وتلاميذ ومعلمات، تضيء على واقع العام الدراسي الجديد في مونتريال: هموم وهواجس، ورغبات في تحسين بيئة التعليم بما يحفظ جودة التحصيل الأكاديمي وراحة الطالب معًا.

المعلمة سهام المحمد: في بعض الصفوف يصل العدد إلى 36 أو حتى 40 طالبًا
بالنسبة للمعلمة سهام المحمد، التي تدرّس صفوف الثانوي الرابع والخامس (أعمار 15-16 سنة)، كانت انطلاقة هذا العام واعدة. تقول: "الطلاب هذا العام أكثر هدوءًا وتشجيعًا مما توقعت. ربما لأنني أعمل في المدرسة منذ خمس سنوات وأصبحت وجهًا مألوفًا لديهم."
ترى المحمد أن تدريس هذه الفئة العمرية ليس سهلًا، لكنه يمثل تحديًا محببًا إليها: "الناس يظنون أن هذا العمر صعب، لكنني أحب التعامل مع طلاب يختبرون حدودهم. أشعر أنني في سباق معهم لأحضّرهم للامتحانات الرسمية ولأرفع نسب النجاح". وتشير إلى أن نسبة النجاح في مدرستها بلغت 80% في العام الماضي في امتحانات الحكومة Les examens ministériels، وهو ما تعتبره إنجازًا مشجعًا.
إلا أن التحديات التربوية ليست وحدها ما يواجه المعلمين. فبحسب المحمد، هناك قلق دائم لدى الأهل والمعلمين على حد سواء من المخاطر التي قد تحيط بالمراهقين، مثل التنمر أو المخدرات. وتضيف: "نحن كلبنانيين لا نقبل هذه الأمور. الأهل يخافون من ضياع أولادهم. شخصيًا، ألاحظ بسرعة إذا كان الطالب يمرّ بظرف غير طبيعي، وأحاول التدخل قبل أن تتفاقم المشكلة." وتضيف أن مسألة برنامج "الهوية الجندرية للأطفال" في المدارس يثير قلقًا لدى الكثير من الجاليات اللبنانية والمسلمة والعربية.
أما عن بيئة العمل، فتوضح أن المدرسة صغيرة نسبيًا ما يحدّ من الفوضى، لكنها تعاني كغيرها من مدارس مونتريال من نقص في الكوادر التعليمية بسبب السياسات التقشفية. تقول: "في بعض الصفوف يصل العدد إلى 36 أو حتى 40 طالبًا. وهذا عدد كبير جدًا يصعّب على المعلم متابعة كل تلميذ كما يجب."
وتتوقف المحمد عند مسألة القانون 21 الذي فرض قيودًا على المعلمات المحجبات في كيبيك. ورغم أنها تمكّنت من الاستمرار في عملها كونها عُيّنت قبل صدور القانون، فإنها تشعر بأن حريتها مقيدة: "لا أستطيع الانتقال إلى مدرسة أخرى. إن غيّرت، أخسر عملي. لكنني متمسكة بحجابي ولن أتخلى عنه."
على الصعيد التربوي، تؤكد المعلمة أنه على الرغم من أن حكومة كيبيك خففت الدعم للمدارس، فإن المدرسة لا تزال تقدّم برامج دعم للطلاب، مثل دروس المساعدة المجانية بعد الدوام، إضافة إلى أنشطة رياضية بارزة جعلت فريق كرة السلة فيها معروفًا على مستوى المنطقة، ولكن ثمة أنشطة أخرى تم تخفيفها بفعل التخفيض الحكومي.
وترى أن التواصل مع الأهل يلعب دورًا أساسيًا: "حين أواجه مشكلة مع أحد الطلاب، أبادر للتواصل مع أهله عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. إشراك الأهل يساعد كثيرًا في ضبط السلوك."
ورغم صعوبة التعامل مع بعض المراهقين في بداية السنة، تقول المحمد إنها تعلّمت أن تفصل حياتها الشخصية عن عملها: "الطلاب كالمرايا. إذا دخلت الصف متعبة أو مشتتة، سينعكس ذلك فورًا عليهم. لذلك أضع كل همومي خارج المدرسة وأركز فقط على التعليم."
وتختم قائلة إن المدرسة، رغم بعض السمعة السلبية التي قد تسمع في محيطها، أثبتت أنها مؤسسة قوية من حيث الكادر ونسب النجاح: "الجيل الحالي يواجه تحديات كبيرة، لكننا كمعلمين نملك الأدوات لمواكبتهم. المهم أن نحافظ على الانضباط ونوفر لهم بيئة تعليمية سليمة."
المعلمة مريم موسى: الدولة مطالبة بتقديم دعم أكبر للمدارس
تدرّس المعلمة مريم موسى صفوف المرحلة الابتدائية، تؤكد أن الوضع في المدرسة التي تعلّم فيها يرتبط مباشرةً بالميزانية التي تخصصها الدولة بناءً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأهالي. وتوضح: "في كيبيك هناك ما يُعرف بالمدارس "المُفَضَّلة" (favorisées)، وهي التي تُمنح ميزانية أكبر لأن نسبة تعليم الأهل ودخلهم أعلى. أما في مناطق أخرى مثل مونتريال الشمالية، حيث الدخل أقل، فالمدارس تتلقى دعمًا أقل، ويظهر ذلك في عدد الأساتذة والخدمات."
لكن موسى تشير إلى أن قرارات الاقتطاع الأخيرة من الموازنة التعليمية تركت آثارًا ملموسة حتى على المدارس المموّلة جيدًا: "المدرسة التي كانت تحصل على مليون دولار سنويًا أصبحت تتلقى أقل. هذا يعني أن الأنشطة تقلصت، والبنية التحتية لم تعد كما كانت، وحتى خدمات أساسية مثل رعاية الأطفال خارج الدوام لم تعد مجانية كما في السابق."
ورغم ذلك، يبقى قلق الأهل متفاوتًا بحسب أوضاع أبنائهم. تقول موسى: "الأهل الذين لا يواجه أولادهم مشاكل لا يسألون كثيرًا. أما الذين يحتاج أطفالهم إلى دعم خاص، فمعاناتهم كبيرة، لأن المدارس لا تستطيع دائمًا توفير خدمات مثل الدعم النفسي أو جلسات مع الأخصائيين. أحيانًا ينتظر الطفل سنة كاملة على لائحة الأولويات قبل أن يحصل على موعد."
وعن تأثير القانون 21 على النقص في الكوادر التعليمية، تقول موسى إن هذا القانون يمنع المعلمات المحجبات من التوظيف بعد دخوله حيز التنفيذ. وتقول: "أنا محجبة وأعمل بشكل طبيعي لأني عُيّنت قبل صدور القانون. لكن أي معلمة جديدة محجبة لا يمكنها الدخول إلى المهنة. أحيانًا يسألونها مباشرة عبر الهاتف: هل تضعين الحجاب؟ فإذا أجابت بنعم، يرفضون توظيفها."
أما عن أوضاع مدرستها الحالية، فتوضح أن نقص المعلمات ليس بارزًا لأن الإدارة لجأت إلى إغلاق بعض الصفوف. وتضيف: "عندنا برنامج إنكليزي مكثف، لكنه استقبل هذا العام عددًا أقل من الطلاب بسبب غياب وسائل النقل. لذلك لم يظهر نقص في الكادر، لكن المشكلة كانت في تقليص الصفوف."
وحول التلاميذ الذين تدرّسهم (أعمار 10-11 سنة)، تقول موسى إنهم ما زالوا بعيدين عن مشكلات المراهقة الكبرى مثل المخدرات، لكن تحديات أخرى تظهر: "أحيانًا أكتشف أن بعض الأطفال شاهدوا محتويات غير مناسبة لعمرهم عبر الإنترنت أو يوتيوب، لأن الأهل يتركون الأجهزة بأيديهم من دون رقابة. هذا يترك أثرًا واضحًا عليهم حتى لو لم يفهموا ما يشاهدونه."
وعن سؤالنا لها عن قلق الأهالي تجاه إدخال برنامج الهوية الجندرية في المناهج، تؤكد موسى أن الصورة ليست كما يُصوَّر خارج المدارس "من لا يعرف البرنامج يعظّمه، البرنامج في جوهره توعوي، يقدّم رسالة توعوية، أُعدّ بالتعاون مع مختصين نفسيين ليكون مناسبًا لكل البيئات الدينية وغير الدينية".
وتضيف: "لكن المشكلة أن بعض المعلمات قد يذهبن بعيدًا في النقاشات مع التلاميذ، ويتحدثن انطلاقًا من خلفياتهن وتفكيرهن الخاص تجاه هذا الموضوع، وخصوصًا أنه لا يوجد مراقبة على ما يقوله المعلمون في الصف. وهنا فإن بعض المعلمات يقلن الأشياء كما هي لأنها بالنسبة إليهن عادية. فيما أخريات يتعاملن بتحفظ وبوعي لأنهن يعرفن أن الطلاب جاءوا من بيئات متنوعة، ودينية. لذلك يختلف التطبيق من معلمة إلى أخرى. كل معلمة لها طبع وتوصل الرسالة بطريقتها".
وعن أبرز ما تحتاجه المدارس الحكومية، تختم موسى قائلة: "الدولة مطالبة بتقديم دعم أكبر للمدارس، لأن حاجات التلاميذ كثيرة والمعلمين غير كافيين، ووحدهم لا يستطيعون سدّ الفجوة. أحيانًا يوجد عدد كبير من الطلاب لديهم صعوبات، والمعلمة وحدها لا تستطيع أن تساعدهم جميعًا. وخصوصًا أن بعض الأهالي ليس لديهم الوعي الكافي للواقع، ويتكلون على المدرسة لتحسين أوضاع أولادهم التعليمية وصعوباتهم، ولكن اليد الواحدة لا تصفق، والتعاون بين الأهل والمدرسة والدولة ضروري لضمان بيئة تعليمية سليمة."
***

السيدة رودينا خشيش: إذا تم تقليص ميزانية المدارس فسيدفع التلاميذ الثمن أولًا
تحدثت السيدة رودينا خشيش، وهي أم لتلميذ في العاشرة من عمره، عن التكاليف المتزايدة والضغوط التنظيمية التي تفرضها إدارات بعض المدارس. تقول خشيش إنها اضطرت هذا العام لنقل ابنها من مدرسة قريبة إلى أخرى تبعد شارعين فقط. ورغم أن الانتقال بدا بسيطًا جغرافيًا، إلا أنه حمل معه اختلافات غير متوقعة: "في المدرسة السابقة لم يكن مطلوبًا شراء كتب، بل كانوا يجمّعون المواد ويصوّرونها ويوزعونها على التلاميذ. أما هنا ففوجئت بأن عليّ دفع مبلغ للأجندة وبعض الدفاتر، إضافة إلى ما يقارب 78 دولارًا لستة كتب وثلاثة كتب للتمارين. هذه أعباء إضافية، خصوصًا أنني أعرف مدارس رسمية أخرى في المنطقة لا تفرض هذه الرسوم".
وتضيف: "الأهل الذين لديهم أكثر من ولد سيشعرون بالفرق أكثر. أعرف عائلات لديها ثلاثة أو أربعة أولاد، والفرق المالي يصبح عبئًا ثقيلًا عليهم"، مشيرة إلى أن أسعار الكتب تراوحت بين 28 و40 دولارًا للمرحلة الابتدائية.
ولا تقتصر الملاحظات على الجانب المالي. فالبلدية، كما تقول خشيش، منعت الأهالي من التوقف أمام المدرسة في ساعات الدوام، وحددت ذلك في إشارة على الطريق من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً: "هناك حارس يمنع الاصطفاف. لكن كيف يفترض بنا أن نوصل أبناءنا؟ نضطر للبحث عن موقف بعيد جدًا، وأحيانًا أصل قبل ربع ساعة من موعد الانصراف ولا أجد مكانًا. هذا أمر غير منطقي إطلاقًا".
وعن ابنها الذي بدأ الصف الثالث هذا العام، تشير خشيش إلى أنه تأقلم بسرعة رغم انتقاله، خيث يشعر التلاميذ عادة بصعوبة عند تغيير المدرسة: "في البداية شعر بالخوف، لكنني طمأنته بأن الأمر طبيعي. المفاجأة أنه وجد زميلة له من المدرسة السابقة في نفس الصف، وهذا ساعده على الاندماج. قال لي بعد أيام إنه مرتاح أكثر من قبل، حتى من ناحية مبنى المدرسة وتجهيزاتها"، على حد تعبيرها.
لكن الأم تبدي قلقًا من نقص الموارد المخصصة لمتابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات سلوكية أو نفسية: "ابني، مثل كثير غيره من التلاميذ، يحتاج أحيانًا إلى جلسات مع مختصة نفسية تربوية تساعده على التحكم بنشاطه الزائد. السنة الماضية لم يستفيد من هذه المتابعة إلا في نهاية العام، لأن المدرسة كانت تكرر أن الموارد محدودة. الملف الشخصي للطفل ينتقل من مدرسة إلى أخرى منذ الروضة، لكن ذلك لا يعني أن الدعم متاح فعليًا في الوقت المناسب".
من القضايا الحساسة التي أثارتها خشيش أيضًا الضغط الذي يتعرض له بعض الأهالي لدفع أولادهم إلى تناول أدوية سلوكية: "الطلاب بطبيعتهم حركيون، خصوصًا الصبيان. لكن عندما يكون الطفل أكثر حركة من المعتاد، تبدأ الإدارة والمعلمات بالضغط على الأهل لإعطائه دواء. هذا أمر متكرر، ولا ينحصر بحالة واحدة فقط. شخصيًا لا أراه الحل الأمثل، لأن الطفل بحاجة إلى تفهّم ومتابعة، لا إلى وصم دائم أو علاج دوائي سريع".
من الملاحظات التي تثير قلق الأمهات أيضًا كثرة غياب المعلمات الأساسيات. وتوضح خشيش: "خلال العامين الماضيين كان هناك غياب شبه أسبوعي لمعلمة أو أكثر، وغالبًا ما تُستبدل بمعلمة بديلة. سمعت من أمهات أخريات أن الظاهرة موجودة في مدارس أخرى أيضًا. ربما السبب هو الضغوط الكبيرة التي تتحملها المعلمات، لكن النتيجة واحدة: تراجع في استمرارية التعليم".
لا تخفي الأم قلقها من أخبار العنف المدرسي في دول أخرى: "قبل أيام وقعت جريمة إطلاق نار في مدرسة بأميركا. فكرت كثيرًا بالموضوع، صحيح أنه نادر هنا، لكن الخوف موجود عند أي أم".
كما تبدي رغبتها في أن يحصل ابنها على دعم إضافي في اللغة الفرنسية: "المدرسة تعطي الإنكليزية مرة واحدة في الأسبوع تقريبًا، ومع ذلك ابني يتقنها بسرعة لأنها لغة سهلة. أما الفرنسية فأشعر أنه يحتاج إلى تركيز أكبر فيها، خصوصًا أننا في البيت نصر على التحدث بالعربية حفاظًا عليها. أريد أن يتقن الفرنسية أكثر لأنها لغة أساسية هنا"، تقول.
وتختم خشيش حديثها مما أعلن عنه رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو بشأن تخفيض ميزانية التعليم وتقليص عدد المساعدين في الصفوف: "إذا تحقق كلام ليغو عن خفض تمويل التعليم فسيكون الوضع أصعب. الصفوف أصلًا مزدحمة، والمعلمات مثقلات بالمهام. المساعدون يلعبون دورًا أساسيًا مع الطلاب الذين لديهم صعوبات، وإذا تم تقليص عددهم بسبب خفض الميزانية فسيدفع التلاميذ الثمن أولًا"، مؤكدة أن الأهالي يتطلعون إلى تعاون أكبر بين الإدارات والأهالي لمواجهة هذه التحديات.

السيدة زينة حيدر: أخشى على ابني من الاختلاط الثقافي المفرط
تجربة التكيّف مع النظام التعليمي الكندي ليست سهلة على الطلاب الوافدين الجدد، خصوصًا حين يقترن ضعف اللغة باختلاف الثقافة. السيدة زينة حيدر، أمٌّ لبنانية تقيم في مونتريال مع ولديها، روت لنا رحلة ابنها حمزة الدراسية منذ وصوله إلى كندا.
تقول زينة إن ابنها التحق بدايةً بصفوف "الاستقبال" المخصصة للمهاجرين (Acceuil)، حيث يُعطى الطلاب وقتًا لتعلم اللغة والتأقلم مع النظام الجديد. إلا أن معلمته لاحظت أنه قادر على الانتقال إلى صف عادي، بينما كانت الأم أكثر تحفظًا: "أنا أعرف قدرات ابني، لكن مستوى اللغة عنده ضعيف جدًا. لم يكن يتجاوب، ربما لأن معظم المحيطين به يتحدثون العربية"، توضح الأم.
وتعترف زينة بأنها كانت حريصة على إبقاء ابنها بعيدًا عن الاختلاط الثقافي المفرط مع رفاق من غير العرب خشية تأثره بعادات المجتمع الجديد. وتضيف: "أنا امرأة أعيش وحدي مع ولديّ، وأعمل كثيرًا. كنت أخاف عليه، فأبقيته معظم الوقت في البيت، يتواصل مع أصدقائه في لبنان عبر الألعاب الإلكترونية." لكنها تدرك اليوم أن هذه العزلة ربما ساهمت في إبطاء اندماجه.
على الرغم من أنه كان متفوقًا في الرياضيات في لبنان، واجه حمزة هنا انتكاسة في المواد العلمية، خصوصًا الرياضيات، بسبب صعوبة متابعته الشرح بالفرنسية. كما أنه صُنف في كندا وفق عمره الزمني لا وفق مستواه الدراسي، ما جعله في صف متقدّم على قدراته الفعلية.
رغم هذه التحديات، تؤكد الأم أن المدرسة الحكومية التي يرتادها ابنها تتمتع بسمعة جيدة في المنطقة، وفيها حضور واسع للجالية العربية واللبنانية، الأمر الذي يخفف من شعور الغربة. وتشير إلى تعاون بعض الأساتذة، مثل معلمته الجزائرية التي فتحت معها باب التواصل بالفرنسية أو العربية بحسب الحاجة.
إحدى الصعوبات الإضافية التي تعانيها العائلة هي نشاط حمزة المفرط وصعوبة تركيزه. فقد لاحظت الأم، التي درست التربية في لبنان، أن ابنها ربما يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) وأنها تحدّثت مع معلمته التي تجاوبت، وقالت إنها ستحاول مساعدته عبر المدرسة.
ورغم قلقها من بعض مظاهر "الانفتاح الزائد" في المجتمع المدرسي مقارنة بما اعتادت عليه في لبنان، تؤكد زينة أن المدرسة توفر لأبنائها بيئة آمنة ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا عند الحاجة، عبر مكاتب مختصة بمواجهة التنمر أو تقديم الاستشارات.
وعن تطلعاتها المستقبلية، تقول الأم: "لا أطالب بالكثير، فقط أن يتاح لابني أن يتجاوز عقبة اللغة ويستعيد ثقته بنفسه. كل ما أتمناه أن يرى في هذا البلد بلد فرص، كما أراه أنا، وأن يستفيد منها ليبني مستقبله."
***

الطالبة سكنة رزق: المدرسة تفتقر إلى المشاريع وإلى الدعم المالي الكافي
تصف سكنة يومها الأول في المدرسة قائلة إنها لم تشعر بتغيير كبير، لكنها ترى أنّه من الضروري أن يكون هناك تجديد دائم في الأجواء المدرسية "أرى أنه من الأفضل أن يقوموا كل سنة بتغيير وتجديد الأجواء حتى يتحمس التلاميذ نفسيًّا للعودة". وترى أنّ لكل طالب طريقته المختلفة في استقبال العام الدراسي الجديد.
أما على صعيد التنظيم المدرسي، فتتحدث سكنة عن حالة من الفوضى، خاصة في اليوم الأول حيث " نعم، خاصة في اليوم الأول، حيث كان الازدحام شديدًا جدًا في الأدراج لدرجة أننا لم نتمكن من الصعود بسهولة. كما أن الإدارة لم تعطنا برنامج الحصص إلا في اليوم الأول، مما سبب ارتباكًا. كذلك ليس هناك خزائن كافية لنضع فيها أغراضنا، نضطر إلى حمل كل شيء معنا طوال النهار بين طوابق المدرسة، وعددها ستة".
وعن تطلعاتها لهذه السنة، تشير إلى أنّ المدرسة تفتقر إلى المشاريع وإلى الدعم المالي الكافي، موضحة: " أشعر أن هناك نقصًا كبيرًا في المشاريع وفي الدعم المادي. المدرسة بحاجة إلى تمويل أكبر ليستفيد منه الطلاب في صفوفهم. مثلًا: الكراسي والطاولات يجب أن تكون أكثر ترتيبًا، واللوحات في بعض الأحيان تتعطل، وكذلك أجهزة الكمبيوتر لا تعمل دائمًا". وتشير أيضًا إلى مشكلة المكيّفات، حيث إنّ بعض الصفوف مجهّزة وأخرى تفتقر إليها، مما يؤثر على تركيز التلاميذ في أيام الحر الشديد.
بالنسبة لأعداد الطلاب، تقول سكنة إنّ الصف يضم في الغالب حوالي عشرين طالبًا، معتبرة أنّ العدد "مقبول طالما لا يتجاوز الثلاثين". لكنها ترى أن هناك حاجة لمراجعة توزيع المواد والأنشطة: "أعتقد أن بعض المواد غير ضرورية. مثلًا حصص التربية البدنية أو بعض المواد الثانوية، يمكن الاستغناء عنها لصالح مواد تفيدنا أكثر في الـ"Cegep"، مثل الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. هذه المواد نحتاج أن نُحضَّر لها منذ الآن بدلًا من حصص لا نرى فائدتها".
وتلفت سكنة أيضًا إلى قلة الأنشطة والرحلات المدرسية، حيث تقتصر في معظمها على نشاطات داخلية محدودة، وتقول: "الرحلات قليلة جدًا، وغالبًا ما تفضل الإدارة النشاطات الداخلية. أرى أن هذا أمر غير جيد، فالتلاميذ بحاجة أيضًا إلى أنشطة خارجية ورحلات تُضفي تنوعًا وحماسة".
أما فيما يتعلق باستخدام الهواتف المحمولة، فتشير إلى أنّ الإدارة شددت بدايةً على منعها، لكنها ترى أن القرار لا يُطبّق بشكل صارم خارج الصفوف: " في الصف ممنوع تمامًا أن يظهر الهاتف، وإذا رآه الأستاذ يصادره مباشرة. لكن في الممرات أو عند الدخول والخروج، لا أحد يهتم إذا كنا نحمله. لذلك أشعر أن هذه القوانين غير جديّة بما يكفي، ولا أحد يلتزم بها فعليًّا".
وفي النهاية، تعبّر سكنة عن أمنيتها الكبرى بأن تولي الدولة والمدرسة أهمية أكبر للدعم المادي، "أتمنى أن يُخصَّص للمدرسة تمويل أكبر، حتى تتحسن تجهيزات الصفوف وظروف الدراسة، فهذا ما يحتاجه الطلاب بالفعل".

الطالب محمد مهدي فنيش: يجب توفير مكان للصلاة بالمدارس والكليات
يشكّل الانتقال من المرحلة الثانوية إلى الكلية CEGEP في كيبيك تجربة خاصة للطلاب القادمين من بيئات مختلفة، إذ يجدون أنفسهم أمام مناهج جديدة وفضاء اجتماعي متنوع. الطالب محمد مهدي فنيش، الذي أنهى دراسته في مدرسة إسلامية، عاش هذا التحوّل بكل تفاصيله.
يقول محمد إن صدمته الأولى كانت في الأجواء العامة التي تختلف جذريًا عن مدرسته السابقة، موضحًا: "في المدرسة كان الجو إسلاميًا بالكامل، أما هنا فهناك تنوّع كبير: مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس وملحدون، وكل يعيش وفق ثقافته". ويضيف أن هذا التغيير كان مفاجئًا، لكنه تعلّم أن يتعامل معه بانفتاح دون أن يتخلى عن ثوابته.
من الناحية الأكاديمية، يرى فنيش أن التواصل مع الأساتذة أصبح أكثر سهولة في الكلية بفضل الأدوات والوسائل المتاحة، ما يمنحه مرونة في طرح الأسئلة وحل الإشكالات الدراسية. غير أن التحدي الأكبر بالنسبة له يبقى في تنظيم الوقت، إذ يعترف: "في العام الماضي كنت أدرس من دون خطة واضحة ولوقت قليل، أما اليوم فأدركت أن عليّ توزيع وقتي يوميًا بين المواد حتى أحقق نتائج ممتازة، ويستطيع أن يكمل في الجامعة اختصاصًا جيدًا."
أما فيما يتعلق بالأنشطة، فيلاحظ الطالب أن مدرسته الإسلامية السابقة وفّرت له متابعة ورعاية أكبر، بينما في الكلية CEGEP يقلّ اعتماد الطلاب على المؤسسة نفسها ويعتمدون أكثر على المبادرات الفردية والجماعية لتنظيم نشاطاتهم.
وعند سؤاله عن النظام التعليمي، لا يخفي فنيش تفضيله للنموذج المعتمد في أوتاوا، حيث ينتقل الطالب مباشرة من المدرسة الثانوية إلى الجامعة من دون المرور بمرحلة الـ CEGEPبرأيه، هذا يوفّر وقتًا وجهدًا على الطالب، خصوصًا أن المرحلة الحالية تفرض ضغطًا كبيرًا.
لكن مطلبه الأبرز يتعلّق بالبعد الروحي، إذ يشير إلى أن غياب مكان مخصص للصلاة في الكلية CEGEP يمثّل مشكلة أساسية بالنسبة له ولزملائه، وأنه يجب توفير مكان للصلاة بالمدارس والكليات، ويعلّق: "في بعض المدارس الأميركية هناك مصليات مشتركة لكل الأديان، وهذا يحترم حرية المعتقد. نحن أيضًا من حقنا أن نوفر لنا مكانًا نصلي فيه، خاصة أن حرية الدين مضمونة بالقانون الكندي."

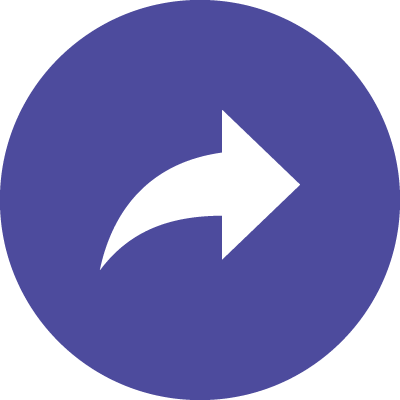




44 مشاهدة
01 سبتمبر, 2025
1539 مشاهدة
27 أغسطس, 2025
491 مشاهدة
09 أغسطس, 2025