دارين حوماني ـ مونتريال
صدر نهار الجمعة في العاشر من شهر تشرين الأول - أكتوبر عن رابطة أساتذة جامعة ماكغيل (MAUT)، التي تضم نحو 900 عضوًا، قرارٌ بتأييد المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. جاء القرار عقب تصويت شارك فيه 111 عضوًا، صوّت 104 منهم لصالح المقاطعة، بينما عارضه 5 وامتنع أستاذان عن التصويت. ويُعدّ هذا القرار خطوة تاريخية، إذ يأتي بعد أعوام من الدعوات الأكاديمية للمقاطعة منذ عام 2005، غير أنّ حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على غزة منذ عامين، وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، قد أسهما في ترسيخ القناعة بضرورة هذا الموقف وكشف طبيعة الجرائم الاستعمارية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان القرار الصادر أن رابطة أساتذة جامعة ماكغيل تعلن تأييدها للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، استنادًا إلى تقارير دولية تؤكد ارتكابها انتهاكات ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وتوصيفها من قبل منظمات مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كنظام فصل عنصري. وأشارت رابطة الأساتذة في بيانها إلى تدمير الجامعات الفلسطينية ومقتل آلاف الطلبة والأكاديميين، وإلى تواطؤ المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في هذه الانتهاكات. ودعت إدارة ماكغيل إلى إنهاء اتفاقياتها مع الجامعات الإسرائيلية، مع التأكيد على أن المقاطعة تستهدف المؤسسات لا الأفراد.

رلى الجردي: من واجبنا كأساتذة أن نفك ارتباطنا بممارسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
قدّمت البروفسور رلى الجردي خلال اجتماع رابطة أساتذة جامعة ماكغيل (MAUT) قرارًا يدعو إلى المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، مؤكدة أن "سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تُطابق التعريف القانوني للإبادة الجماعية"، وأن المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية "متورطة في المشروع الاستعماري ضد الفلسطينيين".
واستهلّت الجردي مداخلتها بالتذكير بأن 170 منظمة مجتمع مدني فلسطينية أطلقت عام 2005 دعوةً إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، موضحة أن "هذه الدعوة تستهدف المؤسسات الإسرائيلية وليس الأفراد"، وأن المقاطعة هي "موقف أخلاقي قبل أن تكون إجراءً سياسيًا".
وقالت الجردي إن جامعة ماكغيل تحتفظ "باتفاقيات تبادل طلابي مع أربع جامعات إسرائيلية تُعدّ ركائز لنظام الفصل العنصري والاستعمار والاحتلال العسكري الموجّه ضد الشعب الفلسطيني"، مضيفة: "أخلاقياً وعقلانياً، لا يسعنا إلا أن نشكك في استمرار هذه الاتفاقيات في ظل الإبادة الجماعية في غزة وتدمير المدارس والجامعات هناك".
وأشارت إلى أن جميع الجامعات في غزة دُمّرت، وأن "آلاف الطلاب والمعلمين قُتلوا أو شُوهوا أو سُجنوا أو هُجّروا"، مشددة على أن "الاعتداءات الإسرائيلية طالت العاملين في المجال الطبي وعمال الإغاثة والصحفيين، وهو ما يتناقض مع كل قيم الجامعات التي تزعم الدفاع عن الحرية والعدالة".
وفي معرض حديثها عن مسؤولية الأكاديميين، قالت الجردي: "من حقنا، بل من واجبنا، كأساتذة وباحثين وأمناء مكتبات ومعلمين، أن نفكّ ارتباطنا بممارسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية. نملك القدرة، كبشر وأعضاء في المجتمع الدولي، على اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء تواطؤ جامعتنا مع نظام الفصل العنصري".
وأضافت أن "الأدلة على تواطؤ المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية واضحة لا لبس فيها، فهي مؤسسات تُعلن صهيونيتها بفخر، وتُبنى على أراضٍ مسروقة، وتُسهم في إنتاج معرفة تُبرّر التطهير العرقي ضد الفلسطينيين". وتابعت: "أي حجة تُساق ضد هذه الحقائق لا تفضح إلا لغة التواطؤ الخبيثة التي تهدف إلى تعطيل مقاطعة عادلة لأنظمة تُرسّخ العنف العنصري وتُطبّعه".
واستحضرت الجردي تجربة شخصية مؤثرة بقولها: "لقد عايشت سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية بشكل مباشر. المذبحة التي ارتكبتها إسرائيل في مخيمي صبرا وشاتيلا عام 1982، على بُعد 15 دقيقة من منزلي، تركت أثرًا لا يُمحى في ذاكرتي. لم أكن بحاجة إلى مرجع قانوني لأدرك أن إسرائيل مارست تطهيرًا عرقيًا ضد الفلسطينيين".
وختمت الجردي كلمتها بدعوة أعضاء رابطة ماكغيل إلى التحرك الفوري: "المقاطعة هي الإجراء الأخلاقي والعقلاني الأساسي الذي نملكه. عندما نتحد، يمكننا العمل من أجل الصالح العام. ولذلك، باعتبارنا أعضاء في رابطة أساتذة جامعة ماكغيل، يتعين علينا أن نؤيد المقاطعة الآن، وليس بعد شهر أو عام، بل الآن.".
***
وقد التقى موقع صدى أونلاين كلّ من البروفسور ميشيل هارتمان والبروفسور داني وهو من أصل يهودي ومن أشدّ المطالبين بقرار المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

الحوار مع البروفسور ميشيل هارتمان Michelle Hartman
القضية ليست حدثًا مؤقتًا، بل تتعلق بمبدأ العدالة والمحاسبة
متى بدأتم التفكير في هذه الخطوة، المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل؟ وهل شعرتم بوجود إجماع بين الأساتذة لاقتراح التصويت على هذا القرار؟
أعتقد أننا نتحدث عن هذا منذ نحو عشرين عامًا. في 2004–2005، كانت فلسطين أوّل من طالب بمقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، وبدأت المجموعات الصغيرة المختلفة تناقش هذا الأمر. على مرّ السنين ازداد العمل والتنظيم: كنا نتحرّك أكثر عند وقوع أزمات، مثلًا أعوام 2008، 2014، 2021، خاصة عندما تتصاعد الأوضاع في غزة. خلال العامين الماضيين، ومع تفاقم الوضع ووقوع مجازر وتصاعد القمع، انضمّ عدد أكبر من الناس وأصبح هناك دافع أقوى للتحرّك الجماعي. الذين اقترحوا القرار هم زملاء أعرفهم منذ زمن، لكنه لم يكن مبادرة فردية؛ بل نتيجة عمل مشترك لعدد من الأشخاص والمجموعات.
نود أن نتعرّف بالتفصيل ما الذي حدث خلال التصويت على القرار؟
كان تصويتًا رسميًا داخل رابطة أساتذة جامعة ماكغيل. تسمح لوائح الجمعية لأي مجموعة مكوّنة من عشرة أعضاء أو أكثر بتقديم قرار مكتوب، وإذا استوفى الشروط، يجب على الجمعية الدعوة إلى اجتماع خاص خلال ثلاثة أسابيع لمناقشته والتصويت عليه.
في هذه الحالة، قدّم 12 عضوًا القرار ووقّعوا عليه، وتم توزيعه مسبقًا على جميع الأعضاء، ثم عُقد الاجتماع لمناقشته والتصويت عليه. الأستاذة رولا الجردي قدّمت القرار أمام الحضور، ثم فُتح باب النقاش، وبعده جرى التصويت.
عدد أعضاء الجمعية نحو 900 عضو، وفي لحظة التصويت كان الحضور 111 عضوًا، وهو رقم يتجاوز النصاب القانوني المطلوب (100 عضو) لجعل التصويت مُلزِمًا. النتيجة كانت 104 أصوات مؤيدة، 5 ضد، وامتناع اثنين.
من المثير أن بعض المعارضين انسحبوا من الاجتماع قبل التصويت في محاولة لإسقاط النصاب القانوني حتى لا يُحتسب القرار، لكن العدد بقي كافيًا لاعتماد النتيجة. بشكل عام، الحضور كان أكبر من المعتاد بكثير، مما يعكس حجم الاهتمام واتساع التأييد لهذه القضية داخل الجامعة.
قد تُثار في الجامعة مخاوف بشأن الحريات الأكاديمية والتعاون وحقوق الأساتذة الذين قد يتأثرون باستبعاد بعض المؤسسات والباحثين الإسرائيليين. ماذا تقولون لهؤلاء؟
هذا أمر مهم. قرارنا لا يستهدف الأفراد؛ لا يتعلق باليهود أو بالإسرائيليين كأشخاص. المقصود هو المؤسسات وليس الأشخاص. الهدف هو منع جامعة ماكغيل من التعاون المؤسّسي مع مؤسسات تُسهِم أو تتواطأ في انتهاكات جسيمة، أن نجعل ماكغيل مسؤولة أمامنا. لا نريد المشاركة في هذا النوع من التواطؤ مع المؤسسات الإسرائيلية. نطالب بمساءلة المؤسسات وإيقاف التواطؤ المؤسسي، ونأمل أن يدفع ذلك زملاءنا داخل المؤسسات الإسرائيلية إلى الضغط على حكوماتهم ومساءلة سياسات مؤسساتهم. هذه فكرة المقاطعة الأكاديمية: استخدام نفوذنا كمجتمع أكاديمي للمساءلة.
ماذا عن حالات التعاون البحثي التي قد تشتمل على تطبيقات عسكرية أو شركات تعمل في مجال الأسلحة؟
القرار لا يتناول الاستثمارات المالية. هو يتعلق بالتعاون المؤسسي. إذا كان هناك تعاون باحث مع مع مختبر في تل أبيب أو حيفا أو في جامعة بن غوريون يساهم في تطوير أسلحة أو دعم نظام يمنع وصول الضروريات الأساسية للناس (طعام، ماء، تعليم آمن)، فنحن نعارض استمرار هذا النوع من التعاون. الوضع الآن في بعض المناطق—خاصة غزة—طبيعة الأضرار كبيرة لدرجة أن الجامعات تتوقف أو تُغلق، والطلاب يتعرّضون للاعتقال والمداهمات ويضطرون للتعلّم عبر الإنترنت لأن الذهاب إلى الشارع غير آمن؛ لذلك علينا أن نأخذ هذا الاختلال في ميزان القوى بعين الاعتبار عند اتخاذ موقفنا.
لذا علينا أن نفكر في هذا النوع من اختلال توازن القوى ونريد أن نحاول استخدام نفوذنا لمحاسبة إسرائيل لأننا نرى أن الزملاء الفلسطينيين غير قادرين على القيام بذلك لمحاسبة إسرائيل. إنهم تحت السيطرة بشكل وثيق للغاية.
كيف تردون على من يزعم أن المقاطعة تستهدف أفرادًا، هل هناك معايير للفصل بين المؤسسات والأفراد؟
هذا تساؤل مشروع وكثيرون قلقون بشأنه. نحن نؤكد على المقاطعة المؤسّسية، لكن هناك حالات رمادية ومحددة تحتاج فحصًا. نعمل وفق مبادئ توجيهية وضعتها الزمالة الفلسطينية وغيرها، ونحاول تطبيق المقاطعة بعدل ومرونة في حالات استثنائية. لكن استثناءات صغيرة لا يمكن أن تُبطل الفكرة الكلية للمقاطعة المؤسسية؛ المقاطعة تستهدف الإطار المؤسسي ككلّ، لا فردًا بعينه.
هل قرار المقاطعة مُلزم إداريًا لجامعة ماكغيل أم أنه توصية من رابطة الأساتذة (MAUT)؟
ما جرى هو أن رابطة الأساتذة أقرّت القرار على مستوى الرابطة، وهي مكلفة الآن بالضغط على إدارة الجامعة لتطبيقه. الرابطة مُلزمة بأعضائها وتعمل نيابة عنهم في مطالبة الجامعة بقطع هذه العلاقات. قد تُماطل الجامعة أو تتجاهل هذه المطالب، كما رأينا سابقًا في قضية الطلا بالتي صوّت عليها أكثر من 8000 طالب لمناهضة الإبادة الجماعية، وفازت جمعية الطلاب عندما طالبت بسياسات معيّنة رغم محاولة الجامعة الاعتراض. لذا، الطريق سيكون عبر الضغط والمساءلة داخل هياكل الجامعة.
ما هو موقف رئاسة الجامعة؟
التصويت تم بالأمس، لذلك لا نعرف بعد كيف سيكون ردّ فعل الإدارة. الصحافة الطلابية نشرت الخبر وتواصلت مع الجامعة، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن. نعتقد أن الإخطار الرسمي قد يستغرق بعض الوقت، وسنتأكد من متابعة هذا الأمر لاحقًا لضمان التزام الجامعة بما كُلفت به.
إذا رفضت الإدارة أو أرجأت التنفيذ، ما هي الخطوات العملية التي ستتخذها MAUT لتنفيذ المقاطعة؟
هذا ما نعمل عليه حاليًا. سنتابع الضغط على رئاسة الجامعة عبر مختلف القنوات ونضع الخطوات العملية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام والأسابيع القادمة. هدفنا هو الالتزام الكامل بالمقاطعة رغم التحديات، والاستمرار في الضغط على الجامعة للقيام بالخطوات الصحيحة.
هل للجامعة صلاحية تعليق أو إنهاء الاتفاقيات المؤسسية دون موافقة أعلى؟
الشراكات المؤسسية تتم عبر توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات، وهي قابلة للإلغاء لأسباب مختلفة، مثل انتهاء صلاحيتها أو عدم التزام أي طرف ببنودها. جامعة ماكغيل لديها اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك أربع برامج تتيح للطلاب التنقل بينها. نرغب في إنهاء هذه الاتفاقيات، وهناك طرق قانونية وإدارية لتحقيق ذلك. نحن مستعدون للعمل مع أي طرف داخل الجامعة لمعرفة كيفية تطبيق هذا الإلغاء بشكل شفاف وعادل. نحن نتحلى بالشفافية التامة. نريد أن نكون منصفين للغاية. لا نحاول القيام بشيء خفي. نحن نقول لإدارة الجامعة: إننا نعتقد أن هذا خطأ، ونريد منكم الالتزام بالقانون الدولي.
كيف سيتم تطبيق المقاطعة عمليًا؟ هل هناك جدول زمني للتنفيذ؟
لا يوجد جدول زمني محدد بعد، لكن هناك رغبة قوية في المضي قدمًا بسرعة. نرى الشعب الفلسطيني ينتظر منذ أكثر من 75 عامًا. لذا نشعر، ونرى الناس في غزة اليوم ينتظرون لمدة عامين. نحن نهدف لإلغاء البرامج التي تتطلب سفر الطلاب إلى إسرائيل، ووقف الشراكات التي ترسل مجموعات طلابية للمشاركة في برامج غير أخلاقية، بما في ذلك مشاريع جديدة قيد الإنشاء.
هناك مركز يجري العمل على بنائه، لم يُبنَ بعد، بشراكة مباشرة بين جامعة تل أبيب وجامعة ماكغيل، بتبرع ضخم من ممول كيبيكي، وهو أيضًا الإسرائيلي سيلفان آدامز. نريد أن يُلغى المشروع. هناك مبدأ أسمى ندعو إليه نحن، نحن مؤيدو هذا القرار، والذي يمثل الأساتذة، وهو إلغاء البرامج اللاأخلاقية التي بدأت حديثًا، بالإضافة إلى البرامج القائمة منذ فترة.
هل قال أحد إن لا داعي لذه االتصويت بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة؟
نعم، أحد الزملاء قال شيئًا مثل: "هناك وقف لإطلاق النار، فلماذا هذا التصويت الآن؟"
لكن ردّنا كان واضحًا: المسألة لا تتعلق بغزة فقط، بل بالمنظومة بأكملها، الاحتلال، والفصل العنصري في الضفة الغربية، واستمرار انتهاك الحقوق الفلسطينية. حتى ما يُسمى بوقف إطلاق النار غالبًا لا يُنفَّذ فعليًا، إذ تستمر الانتهاكات في أماكن أخرى مثل لبنان أو الضفة. في كل مرة يُعلن فيها عن وقف إطلاق النار، يُقتل المزيد من الناس. في اليوم الذي أعلنوا فيه وقف إطلاق النار، قتلوا أشخاصًا في لبنان. لا يمكننا أن نسمي ذلك وقف إطلاق نار.
القضية ليست حدثًا مؤقتًا، بل تتعلق بمبدأ العدالة والمحاسبة، والهدف هو الوصول إلى وضع يعيش فيه الجميع بحرية ومساواة وفق القانون الدولي.
إذا رأينا وضعًا ينتهي فيه الاحتلال ويعيش الجميع بالتساوي داخل فلسطين، وتُطبّق فيه جميع القوانين الدولية وتُنفّذ جميع قرارات الأمم المتحدة، وتحدث كل هذه الأمور، فهذا هو الهدف. نرغب في ذلك لأننا نريد أن نرى الجميع يعيشون في فلسطين بحرية. هذا هو هدفنا. لا نريد مقاطعة.
المقاطعة ليست غاية بحدّ ذاتها، بل وسيلة ضغط سلمية لإيقاف الظلم.
هل هناك تخوّف من أن تتخذ إدارة الجامعة إجراءات ضد الأساتذة الداعمين للمقاطعة؟
بالطبع هناك قلق، وهو شعور طبيعي في بيئة يسودها الخوف والضغط، خاصة تجاه من يدعمون القضية الفلسطينية علنًا. لكننا نرى أن ما نقوم به يقع تمامًا ضمن نطاق الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، والقرار نفسه مدروس بعناية ومبني على مبادئ أخلاقية واضحة.
نعم، قد يتعرّض البعض لمضايقات أو ضغوط غير رسمية من زملاء أو إداريين، لكن ما يحمينا هو هذا الدعم الجماعي الواضح: أكثر من 100 أستاذ وقفوا علنًا وصوّتوا لصالح القرار، بينما دعم آخرون كثيرون الفكرة حتى إن لم يتمكنوا من الحضور لأسباب مختلفة.
لم يعد الأمر يتعلق بشخص واحد أو ثلاثة أشخاص، أو واحد هنا وواحد هناك. بل أصبح الأمر يتعلق بتكاتفنا جميعًا. لم يعد الأمر مجرد مواقف فردية، بل موقف جماعي يوفّر حماية معنوية ومهنية لكل المشاركين. كما قال أحد الزملاء بأننا نعلم أن ما نفعله صحيح، وقد لا يكون سهلًا، لكنه واجب أخلاقي. فالمعاناة التي نواجهها هنا لا تُقارن بما يعيشه زملاؤنا وطلابنا في فلسطين، لا نعيش بلا ماء، ولا نعيش بلا طعام، ولا نُحاصر ولا نستطيع السفر، ولا يُحاصر طلابنا في فصولنا الدراسية ويُزج بهم في السجون، ولا نُوقف عند نقاط التفتيش في طريقنا إلى العمل، ولا نُقلق على عائلاتنا في السجن. ببساطة، لا نمر بهذا الوضع. لذا، نحن قادرون على بذل المزيد، وعلينا ذلك. وأسمع الكثير من الزملاء يقولون ذلك.
***

الحوار مع البروفسور دانيال شوارتز Daniel Schwartz
الأعذار التي يقدّمها الصهاينة الليبراليون أصبحت أكثر انغلاقًا على الذات، وأكثر دفاعًا عن العنف
بصفتك أستاذًا يهوديًا، ما الذي دفعك إلى دعم المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل؟ وهل أثّرت هويتك الشخصية كيهودي على نظرتك إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، ونظام الفصل العنصري والاستعمار والاحتلال العسكري الموجَّه ضد الشعب الفلسطيني؟
نشأتُ في بيئةٍ صهيونية، وإن لم تكن الصهيونية محور حياتي، لكنها كانت جزءًا منها، كما هو حال معظم اليهود الذين نشأوا في الولايات المتحدة. فغالبًا ما تكون المعابد اليهودية هناك ذات توجهٍ صهيوني ليبرالي، وترى فيها العلم الإسرائيلي مرفوعًا.
نشأتُ في كاليفورنيا، في وادي السيليكون، حيث يعيش عدد كبير من المهاجرين الإسرائيليين، وكان لي أصدقاء إسرائيليون كثيرون في الحي والمدرسة، وكانوا جزءًا من حياتي اليومية. كما شاركتُ في منظمات شبابية يهودية، كانت في ظاهرها تهتم بأنشطة الأطفال كالرياضة أو الترفيه، لكنّ البعد المتعلق بـ"الدولة" (أي إسرائيل) كان يظهر لاحقًا، خاصة في المعسكرات الصيفية.
في تلك المعسكرات، قُدِّمت لنا نسخة من الصهيونية تُسمّى "الصهيونية الليبرالية"، تدّعي الإيمان بالحوار والانفتاح، لكنها في جوهرها تعتبر كل من يشكك في "حق إسرائيل في الوجود" شخصًا غير عقلاني أو متطرفًا. كانت هناك فكرة ضمنية بأن بعض الآراء لا تستحق النقاش أصلًا لأنها "جنونية"، وهذا في حد ذاته نوع من الإقصاء. لم أكن أدرك هذا التناقض حينها، لكنه اتضح لي لاحقًا، خاصة عندما التحقتُ بالجامعة.
قبل التحاقي بها عام 2005، سافرتُ إلى إسرائيل لزيارة عمّتي الكبرى التي كانت تبلغ من العمر 98 عامًا، إضافةً إلى بعض أصدقاء والديّ. لم تكن الرحلة جزءًا من برنامج "حق الولادة"، بل كانت زيارة شخصية إلى عمتي. هناك رأيتُ الجدار العازل يرتفع، وشاهدتُ قرى مهدمة ومبانٍ مهجورة كنت أظنها آثارًا من العصور القديمة، ثم اكتشفت لاحقًا أنها أطلال قرى فلسطينية دمّرت. لم أفهم السياق وقتها، لكن المشهد ترك في ذهني أسئلة كثيرة.
وعندما دخلتُ الجامعة، التقيتُ لأول مرة بزملاء فلسطينيين ولبنانيين. في المدرسة، كنتُ قد واجهتُ بعض النقاشات حول الصهيونية مع أصدقاء إيرانيين، لكنها لم تكن عميقة. أما في الجامعة، فبدأتُ أقرأ وأتعرف على وجهات نظر مختلفة، ومع الوقت تغيّرت قناعاتي تدريجيًا. كنتُ في الأصل معارضًا لحرب العراق، فبدأت أتساءل: كيف يمكنني معارضة حرب استعمارية كهذه على العراق، وأدعم في الوقت نفسه دولة تمارس استعمارًا مماثلًا ضد الفلسطينيين؟
في المدرسة، لم نتعلم شيئًا عن الاستعمار كمنظومة عالمية. كانوا يدرسون لنا التوسع الأمريكي غربًا ومذابح السكان الأصليين، لكن دون ربط ذلك بما يحدث في الشرق الأوسط. ربما يعود ذلك إلى أجواء ما بعد 11 سبتمبر، التي منعت أي نقاش يُفهم منه تبرير الطرف الآخر.
ثم في الدراسات العليا، حيث تخصصت في الأدب، توسّعت قراءاتي لأعمال مثل إدوارد سعيد وغيره من المفكرين المناهضين للاستعمار. ومع مرور الوقت، أصبحت رؤيتي أكثر وضوحًا.
بعد السابع من أكتوبر 2023، بدا لي أن ما كنت ألاحظه منذ سنوات تضاعف بوضوحٍ أكبر. الأعذار التي يقدّمها الصهاينة الليبراليون أصبحت أكثر انغلاقًا على الذات، وأكثر دفاعًا عن العنف. وبالنسبة لي، لا يمكن تبرير الإبادة الجماعية مطلقًا، ولا شيء يبرر ما تفعله إسرائيل اليوم.
من خلال تجربتي وحواراتي، أصبحتُ أرى أن ما يُسمّى "التناقض بين العرب واليهود" هو بناءٌ مصطنع، صنعه الاستعمار عبر مبدأ "فرّق تسُد". فاليهود في الجزائر مثلًا عاشوا هناك قرونًا في انسجام مع محيطهم العربي، حتى جاء الاستعمار الفرنسي وخلق الانقسام بينهم وبين المسلمين. وهكذا، تم تهجير اليهود العرب لاحقًا إلى فرنسا أو إسرائيل ضمن عملية استعمارية معقدة.
لذلك أؤيد المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (PACBI) تضامنًا مع زملائي الفلسطينيين، ومع جميع المعارضين للإبادة الجماعية. دائمًا أقول إن الأمر لا يتعلق بالأفراد، بل بالمؤسسات، وأن الجامعات في إسرائيل تدعم الإبادة الجماعية بنشاط. إنهم يطورون أنظمة أسلحة تُمكّنك من حضور دورات تدريبية عسكرية أو تكتيكية. كما يُدربون الجنود كشراكات مع الجيش. والجيش متأصل في جميع مناحي الحياة في إسرائيل. في إسرائيل، كما تعلمون، فكرة "سوبر سبارتا" ليست جديدة.
قلتُ لزميلٍ إسرائيلي في مؤتمر سينمائي عندما دعاني لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية إنني لا أستطيع فعل ذلك، لأن ما يجري الآن من تطهيرٍ عرقي وإبادة جماعية لا يمكن تجاهله. أكدتُ له أن موقفي ليس شخصيًا ضده، لكنه كان مستاءً، وهذا مفهوم. الناس يميلون إلى أخذ الأمر على محملٍ شخصي، لكن الحقيقة أن القضية مؤسسية، وليست فردية.
كيف تم الوصول لهذا القرار؟
بعض الأساتذة، مثل ميشيل في جامعة ماكغيل، يناضلون من أجل تبني قرار PACBI منذ سنوات، بينما آخرون انضموا حديثًا. بصراحة، لولا ما جرى بعد 7 أكتوبر، لما كنا وصلنا إلى هذه النقطة. من المؤلم قول ذلك لأن آلاف الناس فقدوا حياتهم، لكن الواقع أن القمع الممنهج بعد تلك الأحداث، ومنع أي انتقاد لإسرائيل، حتى في كندا والولايات المتحدة، جعل كثيرين يعيدون التفكير.
كان الوصول إلى هذا القرار نتيجة جهود كبيرة من النقاش والتوعية. كثير من الأساتذة كانوا يظنون أن المقاطعة تعني رفض الحديث مع زملاء إسرائيليين في الجامعة العبرية أو قطع الحوار الأكاديمي الشخصي، وهو تصور خاطئ تمامًا. المقاطعة تستهدف بالأساس برامج التبادل الأكاديمي التي تربط جامعات كندية مثل ماكغيل بالجامعات الإسرائيلية الكبرى، وهي برامج تُستخدم لتجميل صورة إسرائيل وتجنيد الدعم لها.
عندما راجعتُ المواد الدعائية لهذه البرامج، وجدتُ أنها تُشبه إلى حد كبير دعاية "حق الولادة" التي تستهدف الطلاب اليهود فقط، ولا تسمح بأي مشاركة فلسطينية. هي برامج تُقدَّم كفرص تعليمية، لكنها في الواقع أدوات دعاية تُشجع على الارتباط بإسرائيل، حتى أن بعضها يدعو صراحة إلى الوقوع في حب إسرائيل والزواج من إسرائيليين.
حين أُثير سؤال "لماذا نقاطع إسرائيل ولا نقاطع دولًا أخرى مثل السعودية أو روسيا؟"، أقول ببساطة: لا توجد لدينا برامج تبادل أكاديمي أو تعاون مؤسسي مع تلك الدول، بينما توجد علاقات وثيقة بين كندا وإسرائيل، وتاريخ استعمار مشابه بين البلدين. فإذا كانت الجامعات الكندية تتحدث عن مصالحة مع السكان الأصليين، ومعالجة الظلم التاريخي، فمن النفاق أن تدعم في الوقت نفسه استعمارًا آخر في فلسطين. وفي الوقت نفسه، إذا وُجِدَت دعوةٌ لمقاطعة الصين أو ميانمار أو أيِّ مكانٍ آخر، فسأُفكِّر فيه بجديةٍ بالغة، إذا أشارت إليه منظمات إنسانية ومدنية.
التشابه بين كندا وإسرائيل وتقارب الشراكات، هو ما أجده مُقلقًا حقًا.
ما هو ردّ الفعل المتوقع من إدارة الجامعة تجاه القرار؟
لا أتوقع منهم أن يوافقوا بسهولة. عادةً تبدأ الجامعات بالتجاهل، ثم الرفض، ثم التشكيك في شرعية التصويت. ربما يقولون إن عدد المشاركين قليل، أو أن التصويت لم يكن ديمقراطيًا كفاية. وقد يحاولون لاحقًا إلغاء القرار أو تعطيله عبر تصويت مضاد.
لمواجهة ذلك، علينا الضغط المستمر على الإدارة لتطبيق القرار، والتنسيق مع المنظمات الأخرى داخل الجامعة، لخلق جبهة ضغط موحدة. الدعم الإعلامي والسياسي مهم أيضًا، خصوصًا مع وجود انتخابات بلدية قد تُشجع بعض السياسيين على دعم القرار.
لكن بصراحة، الآلية الوحيدة القادرة فعلًا على فرض القرار هي "الإضراب". إذا رفضت الجامعة التنفيذ، فالحل هو تعطيلها بالكامل حتى تُجبر على الاستجابة. كندا دائمًا ما تشهد إضرابات، لكن حث الناس على الإضراب أمر صعب. معظم الأساتذة لا يزالون مترددين في اتخاذ خطوة كهذه، خصوصًا في ظل أجواء سياسية غير مستقرة.
هل تخشى من تُعرّضك للفصل أو لعقوبة من الجامعة؟
ليس في كندا، على الأقل ليس كما هو الحال في الولايات المتحدة. هناك، قد يُعرّضك موقفٌ كهذا لحملات تشهير أو فقدان الوظيفة أو حتى تهديدات شخصية. أما هنا، فما زلنا نتمتع بهامش من حرية التعبير، وهو امتياز أدرك قيمته أكثر حين أرى كم من الناس حول العالم لا يملكونه.
أعتقد أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم المباشر: أن نتحدث بوضوح، ونستخدم حقنا في التعبير بحرية، ونقف بثبات على مواقفنا. الدستور الكندي وميثاق الحقوق والحريات يحمينا، لذلك لا أعتقد أن الجامعة تستطيع فصلي بسبب موقفي.
هل واجهتَ أي تحديات شخصية أو مهنية أو انتقادات من زملاء أو طلاب صهاينة بسبب كونك يهوديًا وتتبنّى هذا الموقف؟
ليس كثيرًا. أحيانًا تصلني رسائل إلكترونية من أشخاص غاضبين، لكنها نادرة، وغالبًا ليست من زملاء مباشرين. مرة واحدة فقط تلقيتُ رسالة أثناء الاحتجاجات تتعلق بحماس، لكنها لم تؤثر عليّ.
كنتُ قد شاركتُ في مجموعة حوار بين أساتذة يهود وفلسطينيين، نقرأ نصوصًا ونتناقش حولها، لكن المشروع لم يستمر طويلًا. كنتُ اليهودي المناهض للصهيونية في المجموعة، وزميلي الآخر كان صهيونيًا. كان الأمر مؤلمًا لأنني رأيتُ كم يصعب على البعض التخلي عن صورة إسرائيل المثالية التي تربّوا عليها. أشعر تجاههم بالحزن أكثر من الغضب؛ لأنهم يؤمنون بوهمٍ لا وجود له في الواقع.
لا نتحدث كثيرًا عن الأمر داخل الجامعة، أشبه بعلاقة عائلية يتجنب فيها الجميع الموضوع حفاظًا على استمرار العمل. ومع ذلك، لا أُعمّم تصرفات فردٍ أو رسالةٍ غاضبة على كل الزملاء الصهاينة، فالكثير منهم ببساطة يفضلون الصمت.

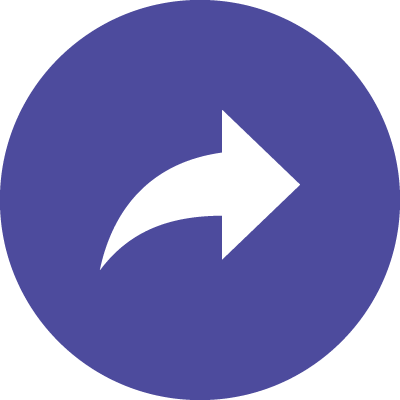





256 مشاهدة
30 نوفمبر, 2025
213 مشاهدة
21 نوفمبر, 2025
267 مشاهدة
20 نوفمبر, 2025