د. إسماعيل الحاج علي ـ غاتينو
الملخص
يبحث هذا النص في التحوّل البنيوي للعلمنة في مقاطعة كيبك، في ضوء القانون 94 الذي أُقرّ مؤخراً لتنظيم مظاهر الرموز الدينية في الفضاء العام، والذي يُمثّل تجلياً معاصراً لتحوّل العلمنة من مشروعٍ إنسانيّ يهدف إلى حماية حرية الضمير والتعدديّة، إلى نظامٍ رمزيّ يمارس مراقبةً خفيّة على الأفراد والجماعات باسم “الحياد ”.ينطلق التحليل من فرضيةٍ فلسفية مفادها أنّ العلمنة حين تنفصل عن بعدها النقدي والإنساني تتحول إلى شكلٍ جديدٍ من الإلزام الثقافيّ يعيد إنتاج الكهنوت في صورة الدولة الحديثة. ومن خلال مقاربةٍ تجمع بين فوكو وبورديو وريكور وطه عبد الرحمن وأركون، يُظهر النص كيف تحوّل الحياد إلى أداةٍ لتأديب الوجدان، وإعادة تشكيل الهوية الجماعية عبر مؤسسات التعليم والقانون والخطاب العام. كما يناقش علاقة هذا التحول بالخوف من التنوّع، وبسعي المجتمع الكيبيكيّ إلى بناء وحدةٍ رمزيةٍ تعوّض فقدان الهوية الكاثوليكية القديمة. ويخلص البحث إلى أنّ الصراع في كيبك اليوم ليس بين الدين واللادين، بل بين نموذجين للحرية: حريةٍ تقوم على الاعتراف بالاختلاف، وحريةٍ تقوم على إخفائه. ويرى أنّ مستقبل العلمنة في كيبك مرهون بقدرتها على تجاوز الحياد الصوريّ نحو علمنةٍ نقديةٍ إنسانيةٍ تُعيد المعنى للفضاء العام وتحتضن الرموز بدل نفيها.
من حياد المؤسّسات إلى تأديب الوجدان
لم تعد العَلمانيّة في كيبك مجرّد حيادٍ مؤسّسيّ كما وُلدت في بدايات القرن العشرين، بل غدت نظاماً لتأديب الظهور الإنسانيّ نفسه، نظاماً يطلب من الجسد أن يتماهى مع الدولة، وأن يُنكر ما لا يُشبهها. فبعدما كانت الحريةُ جوهرَها، صارت المظهرُ مقياسَها؛ وبذلك انتقلت من حماية الضمير إلى مراقبة الوجدان، ومن صونِ الاختلاف إلى تسويته في لونٍ واحد. إنّ ما نشهده ليس تشدّداً إداريّاً، بل تحوّلاً أنثروبولوجيّاً في معنى الإنسان المواطِن، إذ لم يعد الانتماء إلى الدولة عقداً قانونيّاً فحسب، بل تجريداً للهوية من كل أثرٍ لما قبل الدولة [1].
لقد نَبَّه ماكس فيبر إلى أنّ الحداثة البيروقراطيّة تُفرِغ الدين من المجال العام باسم “العقلنة” ، لكنها تُنتج في المقابل ما أسماه “القفص الحديدي” حيث يختنق المعنى تحت ركام التنظيم [2]. وهذا ما يتكرّر اليوم: فحين تُفرَض الحياديّة على الأفراد أنفسهم، يتحوّل الحياد إلى إيديولوجيا جديدة، تُقصي الرموز باسم الشفافية، وتُحاكم الوجوه باسم الحرية.
في منظور هابرماس، المجال العام الديمقراطي يقوم على تفاعل العقول في فضاءٍ عقلانيّ مفتوح [3]، لا على تكميم الرموز. لكنّ القانون 94 يُحيلنا إلى نقيض ذلك: مجال عامّ خالٍ من الاختلافات البصريّة، كأنّ الحقيقة لا تُحتمل إلا عاريةً من ألوانها. فيختلط الهدوء بالقمع، والوحدة بالفراغ، والمساواة بالتطابق.
الخوف من التنوّع وأزمة الهوية الجماعية
ولعلّ شارل تايلور، وهو ابن البيئة الكيبيكيّة ذاتها، عبّر عن المفارقة حين قال إنّ المجتمع الذي يخاف من التنوّع الدينيّ يخاف في العمق من ذاته، لأنّ الدين هو المرآة التي تكشف انقساماته الداخلية [4]. فالقانون لا يواجه الحجاب، بل يواجه هشاشة الهوية الجماعية التي لم تحسم بعد علاقتها بإرثها الكاثوليكيّ القديم ولا مع حداثتها الجديدة.
إنّ ما يجري اليوم ليس انقطاعاً عن الماضي بل استمرارية مقنّعة له. لقد وصف عبد الله العروي الدولة الحديثة بأنّها «وريثة الكنيسة» في ضبطها للمجتمع وتشكيلها للوعي [5]، وكأنّ اللاهوت لم يمت، بل بدّل لباسه: من الثوب الكهنوتي إلى الرداء الجمهوريّ. فالمحرَّمات القديمة عادت بأسماءٍ جديدة — “الرمز الدينيّ” بدل “البدعة”، و“الحياد” بدل “الطهارة”.
من المجتمع التأديبيّ إلى السلطة الحيويّة
من هنا يظهر التوازي الغريب بين ما سمّاه فوكو “المجتمع التأديبيّ” [6] وبين ما تفعله الدولة الكيبيكيّة حين تراقب الوجوه في المدارس. فليست العَلمانيّة سوى تقنية للسلطة الحيويّة (Biopower) التي تُعيد تعريف الإنسان من خلال جسده المرئيّ، فتتحكّم لا في إيمانه بل في هيئته. والسلطة هنا لا تضرب، بل تُشكِّل، لا تُعاقب، بل تُطبع.
التحييد القسريّ للروح ونفي اللغة الرمزية
وإذا عدنا إلى طه عبد الرحمن، نجد أنّه حذّر من «التحييد القسريّ للروح» الذي يحوّل الإنسان من كائنٍ مُلهَم إلى آلة اجتماعيّة [7]. إنّ نزع الرموز لا يُنتج إنساناً حراً، بل إنساناً خاضعاً لتوحيدٍ قسريّ. فحين يُملى على الناس كيف يبدون ليكونوا مقبولين، يُنتزع منهم حقّهم في أن يكونوا ذواتٍ فاعلة في المعنى.
أمّا بول ريكور، فقد بيّن أنّ الرموز ليست مجرّد زينة ثقافيّة، بل هي “لغة ثانية للوجود” [8]، وأنّ محوها يعني تفقير الذاكرة الجماعيّة. فالقانون الذي يحظر الرموز يحظر اللغة التي يتكلّم بها الإنسان عن نفسه، أي يحظر اعتراف الذات بذاتها.
من نقد المقدّس إلى خواء المعنى
في هذا الإطار، يرى نصر حامد أبو زيد أنّ «التقدّم لا يعني نفيَ المقدّس بل وعيَ نسبيّته» [9]. أمّا أن نُنكر وجود المقدّس كلّياً، فذلك لا يُنتج وعياً نقديّاً بل خواءً رمزيّاً. والخواء لا يبني مجتمعاتٍ حرّة، بل مجتمعاتٍ خائفة، تُخفي إيمانها كما يُخفي المريض جرحه عن الطبيب.
وهنا تظهر عبقريّة علي شريعتي حين ربط بين “التحرّر” و“المسؤولية الروحية” [10]: فالمجتمع الذي لا يملك معنىً روحيّاً للحرية سيحوّلها إلى شكلٍ بلا مضمون. إنّ الحياد الظاهريّ لا يُخفي إلا فراغاً داخليّاً يطلب امتلاءه بالسيطرة.
لقد حذّر هنري برغسون من أنّ الحضارة التي تفقد “القوة الحيوية” (élan vital) تشرع في التحلّل البطيء [11]؛ لأنّها تُبدّل الدفق الحيويّ بالانضباط الشكليّ. وهذا ما يحدث حين تتحوّل المدرسة إلى مختبرٍ للامتثال بدل أن تكون ورشةً للحياة.
العلمنة كعودةٍ إلى الكهنوت
وأخيراً، نجد عند محمد أركون أنّ «العلمنة ليست نزعاً للمقدّس بل نقداً مستمرّاً لحدوده» [12]. أمّا حين تتصلّب العلمنة في قانونٍ عقابيّ، فإنّها تعود إلى ما حاربتْه: سلطةِ المنع باسم الحقيقة. فتصبح الدولة كهنوتاً جديداً، يحرس طهارة رمزيّة لا يَعرف معناها أحد.
إنّنا، إذن، أمام انتقالٍ دلاليّ عميق: من العلمانيّة كفضاءٍ لحريّة الضمير، إلى العلمانيّة كنظامٍ للرؤية والانضباط. والمفارقة أنّ هذا التحوّل يحدث في مجتمعٍ بنى هويّته على مقاومة القهر الدينيّ، فإذا به يُعيد إنتاج القهر بأدواتٍ مدنيّة جديدة. ومن هنا تبدأ الأسئلة الكبرى عن معنى الحرية، وعمّا إذا كان يمكن للدولة أن تكون محايدة فعلاً وهي تُقرّر من يُرى ومن يُحجَب.
لاهوت الحياد ومأزق الهوية في الدولة الحديثة
الدولة كخلاصٍ دنيويّ ولاهوتٍ بلا إله
تبدو الدولة الحديثة، في أعمق بنيتها، كأنّها تبحث عن خلاصٍ دنيويٍّ بعد أن فقدت السماء. هي لا تكفّ عن الحنين إلى وحدةٍ ضائعة؛ ولكنّها تستعيض عن الوحي بالقانون، وعن المعنى بالمراقبة، وعن الاعتراف بالتطابق. في كيبك كما في غيرها، تتكرّر الأسطورة القديمة بوجهٍ إداريٍّ جديد: الإنسان يريد أن يصنع جنّته على الأرض، لكنه يخاف من أن يدخلها أحدٌ غيره. ومن هنا تتحوّل العَلمانيّة إلى لاهوتٍ بلا إله، نظامٍ يَعِدُ بالخلاص من سلطة الدين، لكنه يؤسِّس في المقابل لسلطةٍ أكثر تغلغلاً، سلطةٍ تُعيد قولبة النفوس عبر مؤسساتٍ باردةٍ تُمارس الرعاية كإخضاعٍ ناعمٍ [13].
المدرسة كمسرحٍ للهوية والتطبيع
في قراءة ميشال دو سيرتو لممارسات الحياة اليومية، نكتشف أنّ السلطة لا تفرض نفسها فقط بالقوانين، بل أيضاً عبر إعادة ترتيب الفضاءات والمعاني [14]. والمدرسة في هذا الإطار ليست مجرد مكانٍ للتعليم، بل هي المسرح الذي تُعرَض عليه هوية الأمة في هيئة الأطفال. حين تمنع العَلمانيّة الرموز، فهي لا تطلب من التلاميذ أن يتعلّموا فقط، بل أن يتماهوا مع صورةٍ محدّدةٍ للانتماء. إنّها تسلبهم لغتهم الرمزية لتمنحهم هويةً جاهزة، مثل لباسٍ موحّد للروح قبل الجسد.
غير أنّ الهوية، كما يقول بول ريكور، ليست معطًى نهائياً بل سردٌ متجدِّد [15]. والإنسان لا يتكوّن إلا بتعدّد الروايات التي يحملها في داخله. حين تفرض الدولة روايةً واحدةً عن الحياد، فإنها تحوّل التاريخ إلى نصٍّ مغلق، والذاكرة إلى نظامٍ إداريٍّ للمعنى. وهنا نفهم أنّ الخطر لا يكمن في منع الحجاب بحدّ ذاته، بل في إلغاء حقّ الإنسان في أن يروي ذاته بلغته الخاصة.
وقد لاحظت حنّه أرندت أنّ جوهر التوتاليتارية ليس العنف، بل توحيد التجربة البشرية في نموذجٍ واحدٍ [16]. فالمجتمع الذي يخاف من الاختلاف ينزلق إلى خلق “إنسانٍ واحد” يَسهل التنبؤ به والسيطرة عليه. وهذا “الإنسان المحايد” الذي تخلقه العَلمانيّة الصلبة ليس أكثر من شبحٍ إداريٍّ يعيش بلا جذورٍ رمزية، كائنٍ بلا صلاةٍ ولا دهشةٍ ولا ذاكرة، يتكلّم لغةً لا تُصلّي ولا تحلم.
من القهر إلى التطبيع: الدولة كآلة للتماهي الجماعي
لقد حذّر جيل دولوز من أن الدولة الحديثة لا تحكم بالقهر بل بالتطبيع [17]؛ فهي لا تحتاج إلى السجون بقدر ما تحتاج إلى المدارس والشاشات والمناهج. وما يجري في كيبك اليوم نموذجٌ لذلك: تحوّل الفضاء التربوي إلى مختبرٍ للتماهي الجماعيّ، حيث تتلاشى الاختلافات تحت شعار “العيش معاً”. لكنّ العيش معاً، كما يقول هابرماس، لا يُبنى على الصمت، بل على الحوار [3]. إنّ حذف الرموز لا يُنهي الصراع، بل يطمسُه مؤقتاً ليعود أكثر احتقاناً في الخفاء.
وحين ننظر إلى ما كتبه بيار بورديو عن العنف الرمزي [18]، ندرك أنّ الحياد المفروض هو عنفٌ من نوعٍ آخر: إنه يفرض على الأقليات أن تُترجم نفسها بلغة الأغلبية كي تُقبَل. هذا العنف لا يُمارَس بالسوط، بل بالمنهاج. ولذا فإنّ معركة الرموز في المدارس ليست معركة على القماش أو الشَّكل، بل على من يملك حقّ تعريف الإنسان الصالح.
من منظور طه عبد الرحمن، هذا النمط من العلمنة يعكس “اختزال الكينونة في المظهر”، أي تجريد الإنسان من بعده الائتمانيّ، فيتحوّل إلى كائنٍ يُراقَب بدل أن يُؤتمَن عليه [7]. والمجتمع الذي يُحيل الثقة إلى رقابة يفقد جوهره الأخلاقيّ، لأن الأخلاق لا تُقاس باللباس بل بالنية، ولا تُحكَم من الخارج بل تُختبَر من الداخل.
اللاهوت الخفيّ للحياد: من القلق الدينيّ إلى عبادة الشفافية
إنّ الوعي الجمعي في كيبك يعيش مأزقًا مزدوجًا: يريد أن يتحرّر من إرث الكنيسة، ولكنه في الوقت نفسه يحمل في ذاكرته الحاجة اللاهوتية إلى الطهارة. وكما يشير بول تيليش في تحليله للقلق الدينيّ [19]، فإنّ الإنسان لا يتخلّى عن المقدّس بسهولة؛ فإذا طرده من الكنيسة عاد إليه من بوابة الدولة، وإذا نفاه من الزيّ عاد إليه من القانون. وهكذا تتكرّر الدائرة: العلمانيّة التي أرادت نزع القداسة عن الفضاء العامّ، تُقدّس الآن فكرة الحياد نفسها.
وفي فكر إدغار موران، الحداثة التي تفقد وعيها بذاتها تنقلب إلى نظامٍ مغلقٍ على نفسه [20]. فالمجتمع الذي ينسى أنّ العَلمانيّة مشروعٌ إنسانيّ قابلٌ للنقد، يحوّلها إلى عقيدة. وكل عقيدةٍ تُعلَن نهائيةً تتحوّل إلى نقيضها. لهذا كتب محمد سبيلا أنّ “العلمنة التي لا تنتقد ذاتها تُعيد إنتاج الدوغما القديمة في صورة جديدة” [21].
من الإنسان الطبيعي إلى سلطة المرآة
على الجانب الأنثروبولوجي، بيّن كليفورد غيرتز أنّ الرموز ليست زخارف اجتماعية بل خرائط للمعنى [22]. وإذا مُنعت الرموز الدينية، ضاع جزءٌ من الخريطة التي يهتدي بها الإنسان إلى ذاته. المدرسة التي تحظر الرموز لا تُحرّر العقل، بل تقطع الجسر بين الفكر والذاكرة.
أما علي حرب، فقد اعتبر أنّ المجتمعات الحديثة تعيش وهمَ “الشفافية” [23]: كلّ ما يُرى يُظَنّ أنه حقيقيّ، وما لا يُرى يُحذَف من الوجود. والعلمنة في صورتها البصرية تسعى إلى جعل المجتمع شفافاً بالكامل، خالياً من الغموض، لكنّ الغموض هو ما يجعل الإنسان كائناً مفتوحاً على المعنى. إنّ نفي الغموض هو نفيٌ للحياة نفسها.
من منظور عبد الوهاب المسيري، العلمنة ليست نهاية الدين، بل توسيعٌ دنيويٌّ لمفاهيمه القديمة [24]. فالخلاص، والتطهير، والنجاة، لم تختفِ بل تحوّلت إلى مفرداتٍ إدارية. والعلمنة المطلقة تخلق ما سماه “الإنسان الطبيعيّ” الذي يعيش في عالمٍ مسطّحٍ بلا عمقٍ رمزيّ. وهذا الإنسان هو الذي تصنعه المدارس حين تجرّده من رموزه ومن ذاكرته الماورائية.
إنّ المجتمع الذي يُفرِغ الفضاء العامّ من الرموز باسم الوحدة إنما يستبدل الوحدة بالتوحيد، والهوية بالتماثل، والحرية بالامتثال. وفي النهاية، كما كتب كوربن عن “التجلّي والحجاب” [25]، لا يمكن للنور أن يُرى بلا ظلّ، ولا للحقيقة أن تُدرَك بلا حجابٍ يحفظها من الاحتراق. إنّ من يظنّ أنه سيبلغ الحقيقة عبر إزالة كل الحجب سينتهي إلى عمًى أشدّ. وهكذا، فإنّ القانون الذي يَمنع الرموز الدينية بدعوى النقاء البصري، يُحوّل الدولة إلى عينٍ لا ترمش، تراقب كل ما يُرى، لكنها تفقد القدرة على الرؤية الباطنية.
نحو علمانيةٍ إنسانيةٍ نقدية
من هنا، يمكن القول إنّ العَلمانيّة في كيبك وصلت إلى نقطة الانعطاف: إمّا أن تُعيد اكتشاف ذاتها كمشروعٍ للحرية يَقبل بالاختلاف كجوهرٍ للإنسان، وإمّا أن تنغلق في نسختها البصرية الانضباطية فتتحوّل إلى لاهوتٍ جديدٍ يخنق المعنى باسم النظام. ولا نجاةَ للديمقراطية إلا إذا قبلت أنّ التنوّع ليس تهديداً لوحدتها بل شرط بقائها؛ لأنّ المجتمع الذي لا يحتمل التعدّد الرمزي سيُحكم عليه في النهاية بأن يعيش تحت سلطة المرآة، يرى نفسه فقط، ويظنّ أن العالم يشبهه.
المراجع
[1] تشارلز تايلور، Les sources du moi: la formation de l’identité moderne، مونتريال: Boréal، 1998، صـ233–239.
[2] ماكس فيبر، L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme، باريس: Gallimard، 2003، صـ104–110.
[3] يورغن هابرماس، L’espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise، باريس: Payot، 1978، صـ72–80.
[4] Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge: Harvard University Press, 2007, pp. 488–495
[5] عبد الله العروي، مفهوم الدولة، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 1992، صـ145–152.
[6] Michel Foucault, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris: Gallimard, 1975, pp. 219–225.
[7] طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمنة إلى سعة الائتمانية، الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2012، صـ98–105.
[8] بول ريكور، La symbolique du mal, Paris: Aubier, 1960, pp. 38–46.
[9] نصر حامد أبو زيد، النص، السلطة، الحقيقة، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1995، صـ120–128.
[10] علي شريعتي، الحرية والإسلام، طهران: مؤسسة نشر آثار شريعتي، 1983، صـ77–83.
[11] Henri Bergson, L’évolution créatrice, Paris: PUF, 1941, pp. 172–180.
[12] محمد أركون، Critique de la raison islamique, Paris: Maisonneuve & Larose, 1984, pp. 257–262.
[13] ميشال فوكو، Sécurité, territoire, population, Paris: Gallimard/Seuil, 2004, pp. 92–99.
[14] Michel de Certeau, L’invention du quotidien, Paris: Gallimard, 1980, pp. 125–133.
[15] بول ريكور، Soi-même comme un autre, Paris: Seuil, 1990, pp. 21–28.
[16] حنّه أرندت، Les origines du totalitarisme, Paris: Seuil, 1972, صـ311–318.
[17] Gilles Deleuze, Surveiller et punir et au-delà, entretien in Deux régimes de fous, Paris: Minuit, 2003, pp. 155–160.
[18] Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris: Seuil, 1998, pp. 35–41.
[19] بول تيليش، The Courage to Be, New Haven: Yale University Press, 1952, pp. 134–138.
[20] إدغار موران، La Méthode 5: L’humanité de l’humanité, Paris: Seuil, 2001, pp. 410–417.
[21] محمد سبيلا، الحداثة وما بعد الحداثة, الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 2007، صـ201–206.
[22] Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973, pp. 87–92.
[23] علي حرب، تفكيك العقل العربي, بيروت: المركز الثقافي العربي، 1990، صـ145–150.
[24] عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة, القاهرة: دار الشروق، 2002، جـ1، صـ66–74.
[25] Henry Corbin, L’homme de lumière dans le soufisme iranien, Paris: Buchet-Chastel, 1971, pp. 201–210.

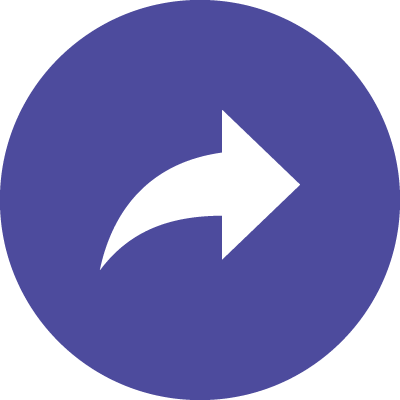



8 مشاهدة
02 نوفمبر, 2025
161 مشاهدة
01 نوفمبر, 2025
142 مشاهدة
30 أكتوبر, 2025